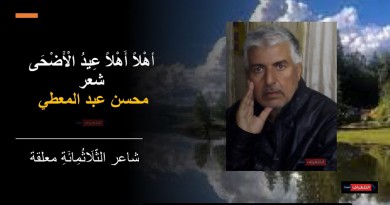سجن الفراشة ” قصة واقعيّة ” ( 11 )
اقرأ : الجزء العاشر
استيقظت ذاكرتي التي عملت سنين على طمر الماضي وطحن معالمه. تذكّرت الأزقّة والأحداث بغربة مفجوعة. زادت قسوة إعاقاتي حين اقتربت من بيتنا المتداعي، فشعرت بالألم ينخرني في تماسكي. صدمني الفقر مجدّداً، وعبّأ مسارب أنفاسي.
البيت من الداخل يتلاءم كليًّا مع حالة الانحطاط التي عدت إليها. أرض جرداء ومتّسخة، فرش منهوك على ضآلته، حيطان ما عاد يُعرف لون طلائها الأصلي، وشحٌ في كلّ شيء.
لن أصف الأسبوع الأول من انسلاخي. هدّني الحنين، وسكنني البكاء وشعور عنيف باليتم والعزلة. فارقني النوم فوق ذلك الفراش الأرضي الذي خصّص لي، فحاولت إبتسام تعزيتي بالقول: “قريباً تتزوّجين وترتاحين”، فسقط عليّ قولها هذا كالمطرقة. صرخت بها: “من قال لك إنني أريد أن أتزوّج؟ سأعود إلى بيروت مهما كلّف الأمر. ليست هذه إلا مرحلة قصيرة وتمضي”. كنت ما زلت موقنة بإمكان سيطرتي على الوضع، وخصوصاً أن أهلي كانوا صبورين معي في الفترة الأولى. قابلتهم بالتأفف والاحتقار، فكاد موسى يفقد صبره.
إنفردت إبتسام بي يوماً مع زوجها، وأطلعتني على سر اللطـف
الزائد الذي أعامل به.
– “مررت قبلك بالاختبار ذاته” قالت، “بعد عودتي من منزل مستخدميّ، عاملوني أفضل معاملة. ولم أكتشف إلا بعد فوات الأوان، أن هذا الحنان غير المعتاد كان لسحب المال الذي جمعته خلال سنين عملي الطويلة. حين فرغت جيوبي، ركلوني كعلبة صدئة. احذري جيداً موسى. سيلجأ معك إلى الخدعة ليأخذ مالك. أمي متواطئة معه، وتعمل على تسهيل الأمور عليه”.
في الحقيقة، لم يعد كلامها عليّ بفائدة كبيرة. كان موسى يعيش مع زوجته وطفلتيه في إحدى الغرفتين اللتين تشكّلان منزلنا في ذلك الحين. يعمل يوماً ويمضي أياماً أُخـَر في السكر والميسر. لم تحتو غرفته على شيء يذكر. باع محتوياتها مراراً لتلبية حاجاته. وجد في عودتي فرصة ذهبية لاقتناص المال، بعدما اشتمّ أن منى يجب أن تكون زوّدتني بكميّة وافرة منه.
لم يكن مجرّد خدعة ما لجأ إليه لإفقاري، بل أشبه بالضغوط النفسيّة والجسديّة عليّ. يطلب بين حين وآخر أن يستدين منّي كميّة صغيرة من المال. “أريد أن أطعم أطفالي”، يقول. تأخذني الشفقة وأنا أرى حقيقة الوضع المزري لعائلته. حين تكرّرت حجّة الاستدانة هذه، بدأت أرفض تلبية رغباته. عندها تغيّرت تصرفاته اللبقة تجاهي، فراح يصرخ ويحطّم ويهجم عليّ، ويضربني مرّات عندما أقف في وجهه. فتتدخّل أمي وترجوني أن “أكسر الشرّ” وأعطيه ما يطلـب. فشعـرت بعجـزي عـن
المواجهة، وخضعت لعنفه حتى آخر فلس لديّ.
واجهتني أمي يوماً بحقيقة كنت أجهلها:
– “هل تعرفين أنني تزوجت بعد موت أبيك رجلاً من عكار يدعى فهد البعريني؟”.
– “حقاً! ولماذا فعلت ذلك؟”.
– “كنت وحيدة وبحاجة إلى سند لي. الرجل أوضاعه مرتاحة، زوجته متوفاة ومعظم أولاده تزوّجوا وغادروا البيت “.
– ” وهل مات الآن؟”.
– “لا، لقد طلّقني منذ أشهر عدة، ويريد الزواج بي من جديد”.
– “وأنت، ما رأيك؟”.
– “أغرتني الفكرة فوافقت عليها، لهذا أطلعك على ما حصل”.
– “شكراً لأنك تطلعينني على ذلك! لا أفهم لماذا تريد امرأة في مثل سنك الزواج من جديد. لديك بيتك وأولادك، برهني مرّة واحدة أنك تصلحين لتكوني أماً. ألا يكفي كيف تهجّرنا من البيت والعائلة كلّ هذه السنين؟ ماذا ستفعلين بنا أكثر من ذلك؟”.
– “ستعيشين معي هناك. لا حاجة لأن تقلقي بعد اليوم على مور الأأأأأاأمور العيش”.
– “وأخي الصغير يوسف، ماذا نفعل به؟ ألا ترين أنه آخذ بالانحراف. يدور في الشوارع طيلة النهار من غير علم أو عمل. لغته قذرة، ولا أحد يهتمّ لمصيره”.
– “سيبقى هنا مع موسى وعائلته. ماذا يمكنني أن أفعل له؟”.
– “لا شيء. أبداً، لا شيء. هل فعلت أصلاً شيئاً صالحاً لنا؟”.
– “لا تكوني قاسية ولئيمة. هذه حياتي ويمكنني أن أفعل بها ما أشاء”.
لماذا أتعب روحي في النقاش والمنطق؟ كان كلّ ما يجري فاقداً تكوينه المنطقي الذي يليق بالبشر. لم أفهم أساساً لماذا انتزعوني من عشّي الآمن في منزل منى. حلّلت كثيراً، فلم أصل إلى نتيجة. حين رفضت ابتزازهم، لماذا لم يبقوني عندها؟ لم تكن عاطفتهم هي السبب طبعاً! وحتى كميّة المال التي أعطتني إياها، لم تكن مغرية إلى حدّ الإقدام على خنق الأحلام من أجلها. لماذا فعلوا ما فعلوا، بحقّ الله؟ ما زلت حتى اليوم أجهل تماماً دوافعهم.
تزوّجت أمي من فهد وعاشت معه في بلدة رحبة. شعرت ببعض الاطمئنان هناك في الفترة الأولى. كان فهد رجلاً ستينياً، يريد زوجة لملء وحدته وخدمته في أيامه الأخيرة. أمي طمعت بماله، “عندما يموت سأتقاسم أملاكه مع أولاده”، همست مرّة في أذني. اعتدت موجة أفكارها المنحطّة. “ستمضي الأيام وأخرج من هذه الوحول من جديد”. كان هذا أملي الوحيد في الحياة، وباب رجائي.
العيش في طبيعة هذه القرية كان ممتعاً. تخلّصت لفترة من شراسة موسى والأجواء المحتقنة التي يخلّفها بحضوره. صادقت راجي الابن الأصغر للعائلة. إرتاح لوجودي في منزل أبيه، وراح يعرض عليّ أن أرافقه في مشاوير الصيد. نمت بيننا ألفة رقيقة، أرخت حدّة غربتي. ولكن سرعان ما استاء الوالد من هذه العلاقة، وكذلك أشقاء راجي. “هل تريد الارتباط بخادمة، لا تعرف ماضيها والأحداث التي عاشتها في منزل مخدوميها؟ أنظر إلى عاهاتها، ألا ترى أنها لا تليق بك؟”. سمعت ذلك يوماً من أحد أشقائه الغاضبين. بعدها، بدأ راجي يبرد وينأى قبل أن يلتحق يوماً بالجيش، ويخرج من حياتي إلى الأبد.
عدت إلى طرابلس لأكون بجانب يوسف، وأبتعد عن أرض جرحي الصغير. كان البيت أشبه بزريبة للحيوانات. باع موسى كلّ ما يمكن أن يباع وصرفه على طاولات القمار، وازداد أخي الأصغر قذارة وضياعاً. كان في الثانية عشرة من عمره، وهو على أبواب مراهقة تعد بالانحراف والمآسي. قرّرت أن أحاول إقناع أمي بالعودة، علّ وجودها يخفّف هذا التمزّق.
أخبرتها فور لقائي بها عن الحالة المزرية التي وصلنا إليها. “لستِ هنا إلا خادمة لديه على شكل زوجة”، قلت لها. “كوني خادمة لأولادك. يوسف بحاجة ماسة إلى وجودك. ألم تري كيف هاجموني بشراسة عندما شعروا بالخطر الذي يمكن أن يسبّبه ارتباط راجي بي؟ ماذا تتوقّعين؟ سيرمونك للكلاب عندما يموت زوجك، ولن تحصلي على شيء”.
واصلت تحريضي وهي متردّدة. سمعني فهد وأنا أحدّثها بذلك، فهاج عليّ كالثور، وطردني على الفور من بيته. لملمت ذاتـي
وغادرتهم ليلاً. “إبقِ إلى الصباح على الأقل”. قالت أمي. كنت أتوقّع منها الكثير، لكنها خيّبتني من جديد.
البيت خاوٍ كما لم يكن في السابق. هجره موسى مع العائلة وعاش عند أهل زوجته، بعدما أفرغه من كلّ محتوياته. يوسف بات ربيب الطرقات والأزقّة. قرّرت أن أجد له عملاً علّه يختبر معنى المسؤولية. اقتنع على مضض بعدما أغرته فكرة أن يكون له ماله الخاص، لكنه لم يثبت في مكان أكثر من يومين. ثم تدبّر أمره كبائع كعك، واستقرّ أخيراً في هذا الخيار لفترة.
بين حين وآخر، كان موسى يغير على البيت ليبحث بين أغراضي عن أشياء ثمينة يمكنه بيعها. استولى على ساعتي، وبعض الحلى الصغيرة التي أهدتني إياها منى، وجاء أخيراً دور آلة التسجيل التي كانت بالنسبة إليَّ مصدر تسليتي الوحيد. وقفت كاللبوة في وجهه محاولة منعه من أخذها، فلم يتراجع. ظلّ يناور ويتحايل ويهدّد، دون أن يفكّر لحظة في ما يمكن أن تعنيه هذه الخسارة. فقدت في النهاية أعصابي، وصرخت به:
– “أفضِّل ألف مرّة أن أحطّم هذه الآلة وأطحنها بأسناني قبل أن تأخذها مني!”.
قلت ذلك ورميتها أرضاً فتحطّمت على الفور. عندما زهق عنادي أحلامه، جنّ جنونه فهجم عليّ وأمسكني من شعري وراح يجرّني كدمية معطوبة. ضربني بوحشيّة توازي قذارته. أفلتّ منه للحظة وهرعت إلى الخارج، فأمسكني عنـد المدخـل
وراح يقذفني فوق الأدراج وهو منهال عليّ بقبضتيه.
في وسط هذه الشراسة، لم أكفّ لحظة عن الصراخ والتحدّي. كان حنقي قد انفجر كالمرجل في باطني، فلم أعد أهاب قسوة الظلم والانكسار. أوصلني الضرب والدفع واللطم إلى باب جيراننا في الطابق السفلي. اندفعوا إلى الخارج بعد سماعهم حدّة صراخي. ركضوا إلى موسى ليوقفوه عن أذيتي، وأدخلوني إلى بيتهم لحمايتي.
– “سأعود إليك أيتها الكلبة”، زمجر في رحيله. ثم غاب عن الأنظار مخلّفاً أصداء طبول مدويّة.
عاد الضياع يسكنني، وسجنتني الوحدة في قاع بارد يصلح للحياة النباتيّة. من يد إلى أخرى، تقاذفتني الحياة في موجات مزبدة مرّات وأليفة في الزمن الباقي. تواتر مضني بين الهناءة والشقاء أفقدني سكينة العادة. لو لم يقذفني الجحيم يوماً إلى حضن وديع، لما كنت مددت رأسي خارج جحري بهذا التحدّي.
عزمت على أن أجول على أشقائي وشقيقاتي من زوجتي أبي السابقتين. في النهاية، يمكن أن أجد في مكان ما صدراً أليفاً وشيئاً من التعزية.
زرت طارق وزهرة وبعدهما ياسمين ومحمود، وحاولت أن أمدّ جسوري باتجاه عائلاتهم. احتضنوني في الفترة الأولى بلطف ومودّة، سرعان ما فقدا بريقهما مع الأيام بسبب ضغوط عائلاتهم الكبيرة ومتطلبات العيش. وجدتني ضيفة ثـقيلة، فاضطررت أن أجول بحقائبي من مكان إلى آخر كالحجّاج الزاهدين بالأرض التي يدوسونها. وبعد مدّة، لم يبق لي إلا خواء البيت، فعدت إليه كما يعود المفجوع إلى أرض أحزانه.
تحوّل يوسف إلى محور حياتي الوحيد في تلك الفترة، وخصوصاً أن أمراً غريباً في وضعه أثار شكوكي ومخاوفي، ودفعني إلى ملاحقته والانغماس في ظلال تصرفاته .
ترك فجأة بيع الكعك، وراح يلازم رجلاً أربعينيّاً يدعى “أبو مازن”. يمضي النهار وشطراً كبيراً من الليل برفقته. يجالسه في مقهى عند “الميناء” يتردّدان إليه معاً، وأنا لا أفهم أيّ رابط يمكن أن يجمع بين رجل في الأربعين ومراهق لم يبلغ بعد الثالثة عشرة. لاحقته مراراً هنا وهناك، فازداد استغرابي وارتفعت حدّة قلقي. يوسف ظلُ أبي مازن الأمين! ماذا يجري بينهما؟ وهل يعقل أن يظلّ أخي متسكّعاً بلا عمل ولا أفق؟
تكثّف غموض العلاقة حين علمت أن يوسف بات يملك باستمرار، كميّات كبيرة من المال غير معهودة بالنسبة إلى وضع عائلتنا.
– “من أين تأتي بهذا المال؟” سألته متّهمة.
– “المال من أبي مازن، ما المشكلة؟ إنه رجل طيّب، يحبّني ويريدني رفيقاً له”.
– “ما الذي يربطك برجل بعمر أبيك؟ إلى متى ستستمر في هذا
التيه والضياع؟”.
– “أليس المال هو المهم! ماذا تريدينني أن أفعل أفضل من ذلك؟”.
– “أنا غير مرتاحة لهذه العلاقة. لم نعد نراك أبداً في المنزل، وأنت لا تفكّر حتى بمستقبلك”.
– ” ما شأنك أنتِ؟ لا تتدخّلي في شؤوني بعد اليوم”.
– “أهكذا تخاطبني أيها الوقح!”.
دفعني بقوّة بعيداً عنه وهو يعلك كلماته بقرف :
– “دعيني وشأني. لم يعد ينقصني إلا أنتِ!”.
حتى أنت يا يوسف!
لم أستسلم بسهولة، فتوجّهت إلى اللغز الأبرز في هذه المعادلة: “أبو مازن”. كانا معاً في المقهى المعتاد، فتجنّبت الحديث إلى أخي بعد الذي جرى بيننا في المرّة الأخيرة، وسألت الرجل مباشرة:
– ” هل يمكنني أن أعرف لماذا يلازمك شقيقي ليلاً نهاراً؟”.
بغت يوسف بحضوري، فبدا كأنه يودّ تمزيقي، وزمجر بين أسنانه:
– “حنان، ماذا تفعلين هنا؟”.
تجاهلت سؤاله، وبقيت محدّقة بالرجل. إبتسم لي بلطف، وردّ بحرارة:
– “أنا أهتمّ لأمر شقيقك. أريد مساعدته، وخصوصاً أنه يتيم ولا
يملك مالاً. أين السوء في ذلك؟”.
– “هل يعقل أن يظلّ خارج المنزل، ويتسكّع في المقاهي بدلاً من أن يجد له عملاً أو يتعلّم مهنة؟”.
– “وضعه الآن جيّد، وهو مرتاح وسعيد. اسأليه فهو صاحب العلاقة”.
– “ما زال طفلاً ولا يفهم شيئاً في الحياة”.
وثب يوسف من مكانه عند سماعه هذه الكلمات، وهمّ بصفعي، لكن أبا مازن وقف بيننا، ولامه قائلاً:
– “لا يجوز أن تهجم عليها، إنها شقيقتك في النهاية”.
فصرخ يوسف في وجهي:
– “اذهبي إلى البيت حالاً، ولا تدعيني أراك هنا من جديد”.
فاضت دموعي، وقذفته ببعض كلمات العتاب والتوبيخ، وقفلت عائدة والخيبة تعصرني.
الأيام التي مرّت أكّدت ظنوني. بدأ أخي يتعاطى المخدّرات، وهو ما زال مدمناً عليها حتى اليوم، أي بعد مرور ثماني سنوات على علاقته بالرجل. وتأكّدت أيضاً أن ما يجمعه بأبي مازن علاقة لواط، اشتراها هذا الأخير بالمال والاغراءات، وجعل حياة صبي بائس تسير على شفير الشحوب والضياع والمرض. لم يكن أبو مازن متزوّجاً، وإنما لقبه هذا من ميراث الحرب، وكنية عرف بها في مرحلة انخراطه في الميليشيات.
لم يأذن لي موسى بزيارة منى. برغم إلحاحي، ظلّ جوابه هـو
هو: “لن تعودي مرّة ثانية إلى المرأة التي أفسدتـك”. الحـرب
قطعت خطوط الهاتف بين طرابلس وبيروت، فلم أتمكّن حتى من سماع صوتها، ومشاركتها آلامي. بدأت أغور في وحدتي ويأسي، ولا كتف أسند عليها تشرّدي. ماذا يريدون مني؟ إذا كانوا لا يهتمّون لوجودي إلى هذا الحدّ، فلماذا لا يفتحون أبواب سجني؟ حتى الطعام كان عليّ أن أستجديه من الجيران والأقارب! طاردني شبح أمل، فشحبت مقاومتي، ونطقت بالجملة عينها التي ردّدتها في منزلها ذات جحيم: “لماذا عليّ أن أحيا بعد اليوم؟”. راح الموت يداعب خيالاتي ويغريني بنداءاته السحريّة، فقرّرت وضع حدّ لهذا الوجع المستشري.
كانت منى قد زوّدتني بصندوق صغير ملأته بأصناف مختلفة من الأدوية. هل كانت تعرف أيّ نوع من الآلام ستضربني؟ إنه الوجع الأكبر، وجع البقاء على قيد الحياة. صلّيت للإله الذي التقيت به عندها، وأنا أعرف أن ما أُقدم عليه أمر مشين بنظره. “كنت فيما مضى موجوداً، فأين اختفيت؟”. ثم رحت أبتلع الحبوب بالعشرات، وغفوت على أمل حياة أفضل في مكان ما خارج هذه الأرض. لكن كلّ ما حصلت عليه كان تلك العاصفة من الكهرباء التي أيقظتني في منتصف الليل، وأنا أشعر بانفجارات هائلة في رأسي تكاد تشلّعني. عَصَرَتْ معدتي حبوب الموت، فتقيّأت بغزارة، وشعرت بأثـقال رهيبة تشدّ مساحات جسدي إلى هاوية بلا منفذ. استيقظ يوسف على حشرجتي، وركض إلى الجيران مذعوراً. فدخلت مجدّداً دوّامة الأطباء، والغرف البيضاء، والكلمات المشجّعة، والتلاشي. اختار لساني أن يصمت طويلاً، وشدت حائطاً نافراً من حولي. بدأ ضوء أسود يلمع في باطني بعد يومين من العلاج. ضوء أشبه بالجنون. في عمق استرخائي يبدأ جسدي بالانتفاض، وخلاياي العصبيّة بإطلاق أسهمها الناريّة. أتشنّج وارتجف ثم أملأ الجو صراخاً، فيهرع الممرضون والممرضات لتهدئتي. لم أستكن في نوبتي الأولى إلا بعدما حقنوني بإبرة مهدّئ أعصاب. وهكذا بدأت علاقتي المتينة بالفاليوم وأفراد عائلته. خرجت من المستشفى وأنا أحمل عطباً جديداً في حياتي، هو النوبات العصبيّة التي راحت تصيبني بوتيرة متقاربة، ومرّات من دون سبب واضح.
لم أسمح لأحد أن يخبر أمي بما حصل لي. لم أكن أريد أن أراها. لكنها عادت بعد فترة بعدما تشاجرت مع زوجها، فطلّقها للمرّة الثانية. أفلتّ في وجهها موجات احتقاري وكرهي. انفجرت كلّ تحفّظاتي، وزادتني عصبيّتي الجديدة زخماً في الصراخ والشجار. لا أعرف لماذا قرّرت في تلك الفترة أن أتمسّح بمآسي الماضي. كنت أريد أن أفهم لماذا تحدث الأشياء بهذه العبثيّة الدامية. تدحرجت صوب طفولتي بحشريّة وتحدٍّ، وقرّرت أن باب الجحيم فتح لاستقبالي يوم دخلت منزل سلمى المفتون، ومن هناك تلقفتني روح أمل المريضة.
حملت جرأتي وقلبي الملتاع وتوجّهت إلى بيت سلمى. وصلـت
إلى الباب فسمعت صراخي وأنين جوعي. صور متلاحقة، قويّة، ونابضة بالآلام. صارعت تردّدي وطرقت الباب. فتح لي وسام شقيق أمل، الذي يكبر وائل بسنتين. لم أكن أخزن عنه ذكريات كثيرة. كان هادئاً ومنسحباً في الماضي، لدرجة أنني كنت أنسى وجوده.
– “أريد التحدّث إلى السيّدة سلمى”، بادرته على الفور.
– “أمي؟ من يسأل عنها؟”.
– “أنا حنان، هل تذكرني؟”.
– “حنان ماذا؟ لا، لا أذكرك!”.
– “أنا الطفلة التي عملت في الماضي عند شقيقتك أمل”.
– “آه، أجل. الآن تذكّرت. لقد أصبحت صبيّة”.
– “نعم. هل يمكنني أن أرى والدتك؟”.
– “أخشى أنه لا يمكنك ذلك، لأنها توفيت منذ أربع سنوات”.
– “توفيت! أرجو أن يرحمها الله بعد الذي فعلته بي”.
– “لماذا تقولين ذلك؟ ماذا فعلت بك؟”.
– “ألا تدري؟ كنت شاباً يوم عملت لديكم، ولا بدّ من أنك كنت تشاهد ما يجري لي في منزلكم وفي منزل أمل. لكن لا أحد وقتها كان يهتمّ بمصيري إلى درجة أنك نسيت الآن ماذا حلّ بي!”.
– “إذا كنت تقصدين تصرفات أمي القاسية، فهـي كانت كذلـك
حتى مع أولادها. على أيّ حال، كان هذا منذ زمن بعيد، فلماذا
ننبشه الآن؟”.
– “هذا الزمن البعيد، لم يكن يوماً بعيداً بالنسبة إليّ. ما زال حاضراً ومتفشّياً في روحي، وأظافره تركت بصماتها في جسدي المعطوب. كنت أريد أن أحدّث أمك بهذا، وربما أمل لو كانت موجودة. هل تدري أيّ عذابات أذاقتني أختك؟”.
– “حنان، أرجوك، لست أنا المسؤول عما حدث لك. إذا كنت أنتمي إلى هذه العائلة، فهذا لا يعني أنني أوافق على مثل هذه التصرّفات. الأجدر بك أن تلومي أهلك على ماضيك، فكلّ شيء كان يحصل برضاهم”.
– “هذا صحيح، وأنا أكره أهلي لذلك. لكنكم تتحمّلون جميعاً مسؤولية عذاب طفلة. أنت كنت تشاهد الظلم وتصمت، كيف تفسّر موقفك هذا؟”.
– “ربما كان عليّ أن أفعل شيئاً، ولكن هل كان على أمك بعد كلّ ما عانيته عندنا، كما تقولين، أن توافق على الزواج بأبي؟”.
سمعت جملته الأخيرة، من غير أن أفهم ماذا قصد بها. أمي وافقت على ماذا؟ أعدت كلامه في رأسي لأستوعب حقيقة قوله، ثم سألته بدهشة مطلقة:
– “ماذا قلت عن أمي؟”.
– “ألا تعرفين أن أمك تزوّجت من أبي لأكثر من سنة؟ اذهبي واسأليها إذا كنت لا تصدقين”.
صعقت من هول ما سمعت. أصابنـي خـدر مفاجـئ حطّـم
أعضائي، فتساءلت بشرود ظاهر:
– “لماذا فعلت ذلك؟”.
شعر وسام بصدمتي، فحاول التخفيف عني بنبرة صوته المتعاطفة:
– “صدمت أنا في الماضي من زواج أبي هذا. لا شيء يجمعه بأمك. لكنني فهمت أنه أراد أن يجد من يهتمّ بشؤون المنزل، ويؤازر وحدته عندما نتفرّق عنه. آسف لهذا القول، لكن هذا ما حصل!”.
الخبيثة! الخبيثة! كيف استطاعت أن تلحق بي كلّ هذه الدناءات؟
غادرت كالعاصفة وقلبي يخفق بالذل والغضب. عانيت الويلات من وحوش هذه العائلة، وهي اختارت أن تتقرّب منهم بأحطّ الوسائل. وصلت إليها وقذفت على الفور حممي في وجهها:
– “هدى، ما هي الحقارات التي فعلتها أيضاً في غيابي، ولم تطلعيني عليها بعد؟”.
ارتعشت لنبرتي. اقتربت مني وصفعتني من غير أن تفهم عن أيّ شيء أتكلّم.
– “أنا أمك ولست هدى! لا تخاطبيني بهذه اللهجة بعد اليوم”.
– “لن تسمعي مني كلمة أمي أبداً، ولن أقابلك إلا بالاحتقار الذي تستحقينه. هل يعقل أن تتزوّجي والد أمل!”.
أجابت على الفور وكأنها كانت مستعدّة لهذه التهمة:
– “تزوّجته من أجلك! هل تفهمين؟ أردت أن أنتقم مـن العائلـة
التي عذّبتك”.
– “وهل انتقمت منها بمضاجعتك خليل المفتون؟”.
– “أيتها الكلبة! لسانك بات أخبث من لسان الأفعى. فعلت ما رأيته مناسباً، هذا شأني”.
– “كم أشعر بالمذلّة وأنا أجوب طرقات طرابلس. كنت أسمع كلاماً كثيراً عنك وأحاول ألا أصدقه. تزوّجت ثلاث مرّات حتى الآن، هذا على الأقل ما أعرفه. وهربت مرّة في خلال وجود أبي في السجن مع رجل إلى سوريا. عاشرت طويلاً “أبو فادي”، وعشرات الرجال غيره كما سمعت من أبناء الحي. أيّ سلوك شائن لم تقدمي بعد على ارتكابه! ولديك الجرأة الآن لصفعي والإدعاء بأنك أمي. لماذا لم تتركوني أحيا جهلي المطبق في منزل منى؟ لماذا أعدتموني إلى هذا الوكر؟”.
ظلّ صمتها مطبقاً، لكن غضبها بدأ يقذف شراراته من عينيها المشتعلتين.
– “لماذا طلّقت الرجل على أيّ حال؟”.
– “كان يمنعني من الخروج من المنزل، إضافة إلى بخله وحجبه المال عني”.
– “ألا تعرفين أنه أرادك خادمة في منزله؟ هل كنت تتوقعين منه تصرفاً مختلفاً؟”.
انصرفت عنها مسفوكة الأحاسيس. بعد أيام عادت إلى زوجهـا
للمرّة الثالثة، ثم طلّقها نهائيًّا بعد مدّة، فآبت أخيراً إلى بيتها.
في وحدتي وضعفي، بدأ شخص واحد يهتمّ بي وهو “علي” إبن خالتي. يتردّد على منزلنا حاملاً الطعام وأغراضاً مختلفة. فاجأني مرّة بقوله إنه يحبّني. أشفقت عليه، فلم يكن قلبي في تلك الفترة يتّسع للحبّ. واجهت تودّده بالرفض، وأفهمته أنني خارج عالمه في الوقت الحالي.
جاءني موسى في إحدى المسايا مقنّعاً ببشاشة غير معهودة.
– “خير إن شاء الله، ماذا هناك؟”، هاجمته على الفور.
– “لقد تدبّرت لك عملاً، أظن أنه سيعجبك”.
– “ما هو؟”.
– “هناك رجل محترم يسكن في منطقة الميناء، يريد صبيّة تهتمّ بتدريس أولاده. تسكنين عنده وتتقاضين أجراً مقبولاً”.
أغراني الموضوع، ومسّ ولعي الدفين بالاهتمام بالأطفال. وافقت من غير تردّد، ولم أفكّر حتى لماذا عليّ أن أنام في منزل هذا الرجل، طالما أن المطلوب هو تعليم أولاده.
وصلنا إلى بيته الفخم، فتركني أخي هناك بعد محادثة قصيرة بينهما. كان الرجل في أوائل الخمسين من عمره. حاول أن يكون لبقاً في حديثه، فسألني إذا كنت جائعة وأريد تناول الطعام.
– “لا، شكراً. ولكن أين أولادك؟”.
– “في رحلة استجمام مع زوجتي خارج البلاد”.
– “إذاً ما الذي أتى بي إلى هنا؟”.
– “ماذا تقصدين؟”.
– “ألست هنا لأعلّم أولادك؟”.
– “من قال ذلك؟ ألم يخبرك موسى بالأمر؟”.
– “أيّ أمر؟ قال إنك بحاجة إلى من يهتمّ بتعليم أولادك”.
– “لا، أنا بحاجة إلى فتاة لتعيش معي. هذا ما طلبته من أخيك. ألستِ هنا برضاكِ؟”.
صمتت قليلاً تحت وقع الصدمة، وحاولت أن أجد مخرجاً لهذه النتانة.
– “أعرف أن لا ذنب لك في كلّ ما حصل، ولكن هل يعقل أن يكون أخي قد باعني إليك؟”.
– “لم أعرف أنه سيأتي بأخته. أعطيته المال ليتدبّر لي صبيّة ترضى بالعيش معي في هذه الفترة”.
بدأ الجنون يطرق جدران صدري. خفت من عزلتي في صندوق مقفل، في مواجهة رجل يبحث عن اللذّة.
– “لست الفتاة المطلوبة، أجبته. موسى خدعني كما خدعك. إنه أسوأ البشر وأكثرهم انحطاطاً على هذه الأرض. ولكن أرجوك لا تؤذني، دعني أنصرف”.
قلت هذا وانفجرت ببكاء مرّ ومفجوع.
أظهر الخمسيني عن بعض نبل يملكه، حين لمس صدقي وطعنتي المسمومة. طمأنني بكلمات متفهّمة، وأكّد لي بأنه لن يمسّني.
– “أنتِ ابنتي منذ هذه اللحظة. أدخلي إلى الغرفة وأقفلي البـاب
عليك من الداخل، إذا شئت. غداً صباحاً سأعيدك إلى المنزل”.
لم تعد تدهشني سهام الشرّ التي أتلقاها من أناس أتقاسم معهم الدماء ذاتها، وتفاصيل أُخَر. حين يغرز الشيطان أظافره فهو يفعل ذلك بلا منطق ولا رحمة. كلّ طعنة كانت تزيدني التهاباً وجرأة. لقائي المجنون بموسى كانت نتيجته نوبة عنف بذيئة من قبله. بين لطمة وأخرى، أبصق في وجهه أبشع النعوت والحقارات. حين انتهى موسم استعبادي في البيوت، أراد أن يجعل مني عاهرة أدرّ عليه ذهباً. غلظت مقاومتي مع الوقت، واكتسبت معها حيلة في التعاطي مع أهلي، إلى حين يشتدّ عودي، فأرتفع بأجنحتي بعيداً عن مستنقعات الملح والكبريت. بات لديّ هدف واضح لن أتراجع عنه بعد اليوم: مغادرة طرابلس نهائيّاً وإقفال الباب خلفي بحواجز من نار. بدأت أحفر مخطّطات واضحة لأهدافي. تجاوبت مع ملاطفات ابن خالتي، ووجدت فيه باباً للحريّة. فاجأته يوماً بقبولي الخطبة منه، فشعر بسعادة لا توصف.
– “علي، قلت له، لا أشعر حاليًّا بالحبّ تجاهك. أنت شخص لطيف وحنون، يمكنني أن أعتاد عليك، وقد يأتي الحبّ في وقت لاحق”.
كان راضياً بأيّ شيء. أراد أن يكتب كتابه عليَّ، فمانعت. لا أريد أن أرتبط بعقود شرعيّة. كنت في باطني أنظر إلى العلاقة كنفق عبور، وليس كواحة توق وانتظار. بعدما استرخـى فـي
فرحه، حدّدت له شرطي الوحيد للقبول به:
– “أريد زيارة منى في أقرب وقت ممكن. تعرف علاقتي بهذه المرأة. أريد منك مساندتي في إقناع موسى”.
وافق أهلي سريعاً على فكرة خطبتي علي، فدخلت حياتي في راحة مؤقتة نتيجة وجود شخص يهتمّ بي، ويعطف على اهتماماتي. ظلّ نظري شاخصاً إلى البعيد، وتصميمي يبحث عن منافذ مضيئة تحرّرني نهائيّاً من تلك الكوابيس التي ما انفكت تراودني، وتكشف عن بشاعاتها طعنة بعد طعنة.
تابعونا : الجزء الثانى عشر

اقرأ اجزاء الرواية :